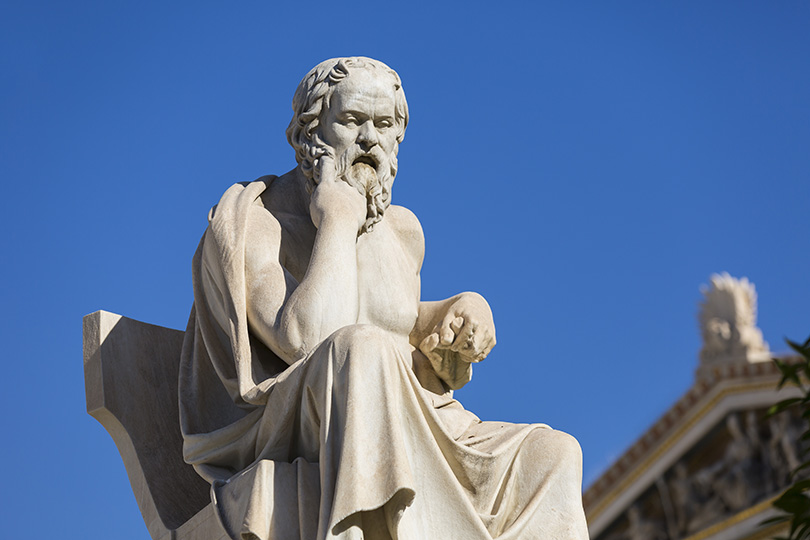لقد كان الإغريق أول قوم في أوروبا يخرجون من الوضع القبلي البدائي، ويصنعون مدنية وثقافة متنامية، قبل الميلاد بستة قرون. فهم بداية الحضارة الأوروبية، ومن المعروف عن الحضارة الاغريقية تحقيرها لشأن العمل اليدوي القائم على الحس والتجربة، الى حد التردد في اعتبار من يمارسه من العبيد والنساء بشراً!
فقد نُسب الى سقراط قوله: «ان العبيد مجرد آلات حية لخدمة السادة الأحرار المتفرغين لممارسة فضيلتي التأمل والصداقة». فلسفة القرن العشرين، يمنى الخولي، ص39. فالإنسان عندهم هو الرجل الذي يمارس التأمل العقلي الخالص والصداقة؛ ليتحاور مع أصدقائه في نتاجات تأمله واستنباطاته العقلية.
وفي ذروة الفلسفة الإغريقية استطاع أن يصوغ أرسطو منهجاً للبحث ينسجم مع روح عصره وروح الحضارة التي يعيش في كنفها، فكان الاستدلال بالقياس هو المنتج للمعرفة اليقينية.
وقد سيطر هذا المنهج العلمي على مختلف مناحي المعرفة سيطرة كاملة حتى القرن السابع عشر، ولسيادته طيلة هذه المدة أي قرابة 2000 سنة سبب مهم،
وهو مناسبة المنهج العقلي كمنهج علمي لطبيعة المسائل المبحوثة في زمانهم، وهي في أغلبها مسائل خارجة عن حدود المادة والطبيعة، وتبحث عن العلل البعيدة والمجردة الخارجة عن عالم المادة.
ثم جاءت بعدهم الحضارات المسيحية والإسلامية والتي تشاركهم طبيعة الأسئلة المطلوب الإجابة عنها، وجُلها المسائل الدينية تبحث عن أمور غير مادية كالله والملائكة ونحوها، فاستمرت الحاجة لهذا المنهج، وقُدم على غيره من مناهج المعرفة.
ولم يتزلزل عرش القياس المنطقي إلا عندما تغير توجه المجتمع من التأمل في القضايا الكلية والعلل والأسباب الأولى الى الاهتمام بالطبيعة وكيفية السيطرة عليها، فلعجز المنهج الاستنباطي العقلي، وعدم قدرته على توفير الأجوبة المقنعة للعلماء، ضاق به الأوربيون ذرعاً، وراحوا يبحثون عن مناهج جديدة ملائمة لأسئلة العصر الجديد.
فقد كان للكشوف الجغرافية التي أخبرت إنسان عصر النهضة في نهايات القرن الخامس عشر أن العالم أوسع كثيراً مما تصور أرسطو والأقدمين، أثر كبير في زيادة نهم الأوربيين لتطويع الطبيعة، والنظر اليها من منظور خارج عن النصوص الدينية المقدسة، يقول هيزنبرك: «ولم يكن من قبيل الصدفة أن تصبح الطبيعة في ذلك العصر موضوعاً لا علاقة له بأمور الدين، فالطبيعة أستقلت عن الله وعن الإنسان أيضاً، وهذا ما يستوجب الدراسة». الطبيعة في الفيزياء المعاصرة، فيرند هيزنبرج، ص12.
ومع نهايات القرن السادس عشر كان السؤال عن الطبيعة قد ارتفع الى الصدارة بعد طول اختفاء، وأوشك أن يكون سؤال العصر الذي تنشغل به جميع العقول الكبرى، من فلاسفة ومفكرين، بل كانت الطبيعة هي موضوع حوار وجهاء القوم من رجال الكنيسة والبلاط، وحتى في صالونات سيدات المجتمع.
وسرعان ما توالت المتغيرات على كافة الأصعدة، وظهرت المطبعة وبدأت الماكينات وباقي الاختراعات بالظهور، فراحت العقول الواعدة تتلمس الجديد من كشوف العلم الطبيعي، وحينئذٍ طغى الإحساس بعقم وجدب المنطق الأرسطي، بل اتهامه بالتسبب بحرمان البشرية وتأخير تقدمها، لموقفه السلبي من الطبيعة والمهتمين بها، كما تقدم في بداية المقال.
ومن ثم أصبح هم الفلاسفة الأول هو البحث عن منهج جديد يلائم الروح الجديدة ويلبي المتطلبات المستجدة للعصر الجديد، فكان القرن السابع عشر هو قرن المناهج، ابتداءاً من ديكارت وكتابه الرائد "خطاب في المنهج" ومروراً بسبينوزا ورسالته في إصلاح العقل، والمنهج الرياضي لليبنتز، وصولاً لفرانسس بيكون، وكتابه "الأورجانون الجديد"، والذي كان الأجدر في التعبير عن روح عصره، باستقطابه لسؤال الطبيعة وتبنيه الدعوة للمنهج التجريبي المناسب لها. فأضحى بيكون الأب الشرعي للمنهج العلمي التجريبي وأساس شريعة العلم الحديث، فتنقش مكتبة الكونكرس الأمريكي في واشنطن ـ أكبر مكتبة في العالم ـ اسمه على إحدى بواباتها المذهبة بوصفه واحداً من الذين قادوا البشرية الى العصر الحديث.
إذن المنهج العلمي الذي يسود هو عادة ما يتناسب مع اهتمامات المجتمع، وطبيعة الأسئلة المراد إجابتها، فرأينا أن الإغريق لما كانوا يزدرون الطبيعة، شاحت وجوههم عنها، ولم يهتموا بتقرير منهج علمي لها، بينما كان جُل اهتمامهم بتحصيل الكليات والمعاني المجردة، والذي لا يناسبه ـ كمنهج علمي ـ إلا القياس العقلي البرهاني، فاهتموا به زياد اهتمام. ولما تغير التوجه الاجتماعي وزاد اهتمام العلماء والنخب بالطبيعة، وملاحظة عدم نفع المنهج العقلي في ذلك، اهتموا بالمنهج الاستقرائي وأعلوا شأنه، وشيدوه على أنقاض المنهج الأرسطي العقلي.
والآن نجيب عن السؤال الذي جعلناه عنواناً للمقال: فليس المنهج العقلي خاطئ في ذاته، فاضطر الباحثون للبحث عن منهجٍ آخر، وإنما للمنهج العقلي ميدان يختلف عن ميدان الاستقراء والمنهج التجريبي، ولا ينفع أحدهما إذا أُعمل في ميدان الآخر، فإذا كانت المسألة المبحوثة من الأمور المادية وضمن نطاق الطبيعة، فلابد من إعمال المنهج الحسي التجريبي، ولا ينفع المنهج العقلي حينئذٍ، كما إن المسألة إذا كانت خارج نطاق المادة فلا يجوز عمل المنهج الحسي التجريبي لاختصاصه بالمادة، ولابد من اعتماد المنهج العقلي الاستنباطي.
ومما يؤيد ما ذهبنا اليه، من ان سبب الاهتمام بالمنهج العقلي او المنهج التجريبي هو طبيعة اهتمام المجتمع او قل طبيعة المسائل المبحوثة، أن قدماء الصينين كان منهجهم العلمي تجريبي محض، لاهتمامهم بالمادة، فقد كان العلِم الصيني يسير في مسار مختلف ومستقل عن المسار الغربي (الإغريقي)، ولم يعرف الصينيون شيئاً عن أرسطو وأقليدس وبطليموس، وبالتالي افتقر العلِم الصيني منذ بواكيره وحتى مشارف العصور الحديثة الى المنطق البرهاني والرياضيات الاستنباطية والأصول النظرية التي برع الإغريق في صياغتها، وضلت الرياضيات الصينية متعثرة مرتبكة يعتمد العد فيها على استخدام العصي، ولم يعرفوا الترقيم العربي ولا الهندي او استخدام الصفر، ولا عرفوا شيئاً عن حساب المثلثات، وبالتالي لم يعرفوا شيئاً ذي بال عن الفلك لتوقفه على حساب المثلثات، يقول تومي هف: «عوضوا ذلك بتوظيف فلكيين عرب في بكين منذ القرن الثالث عشر، وفي هذا التاريخ عرفوا لأول مرة الترقيم والنظام العشري والصفر واستخداماته».
بالمقابل نجد للصينيين مساهمات كبيرة في العلوم التطبيقية (التجريبية)، كعلم الطب فقد ذاعت شهرة الطب الصيني، وكثير من الابتكارات كالساعة المائية والورق والبارود ... وغيرها كثير. يقول جوزيف نيدهام المتخصص بالحضارة الصينية: «إن العلم الصيني شبه تجريبي وتطبيقي في جملته؛ لذا كانت الجوانب النظرية فيه أقل تقدماً. وفي غضون القرنين الأول والثاني الميلاديين كانت الصين قد بلغت قمة من قمم التقدم العلمي والتقني عبر التاريخ، لذلك من الناحية التقانية (التكنلوجية المعتمدة على التجربة) يحق اعتبار الصين غاية وذروة الحضارات الشرقية القديمة». العلم والحضارة في الصين. 1954.
بل حتى الإغريق أنفسهم لم يهملوا المنهج الحسي تماماً، فقد خصص أرسطو باباً خاصاً للاستقراء ـ الذي يمثل المنهج التجريبي، إلا أنه لم يعول عليه كثيراً، ولم ينزله منزلة القياس البرهاني ـ كذلك نجده استعمل الحس والتجربة في علومه الطبيعية، حتى أنه أوصى قادة الإسكندر بجلب عينات من النباتات والحيوانات من المناطق المحتلة.
وخلاصة ما تقدم ان من يحدد المنهج العلمي السائد هو الحاجة العملية لذلك المجتمع، فلما كانت طبيعة الأسئلة والمباحث غير مادية، اختار الإغريق المنهج العقلي، وقدموه على غيره، لعدم نفع هذا الغير فيما يرومون بحثه، وعندما تغيرت طبيعة الأسئلة نتيجة زيادة اهتمام المجتمع الغربي بالمادة والطبيعة، انتقلوا للمنهج التجريبي الأكثر جدوى في المادة من المنهج العقلي.
ومنه يظهر الخطأ الجسيم الذي ارتكبه أوغست كونت عندما حقب المسار الفكري والتقدم العقلي للبشرية بالحقب الثلاث (اللاهوتية والفلسفية والعلمية)، معتبراً أن نزوع الإنسان للدين او للفلسفة كان نتيجة عدم قدرته على معرفة أسباب الظواهر المادية، فلعجز الإنسان عن معرفة أسباب البرق مثلاً، نسبه للإله "ثور" من الآلهة النوردية الاسكندنافية القديمة، وبتقدم البشرية ونضوجها الفكري صار ينسبه لبعض العلل والأسباب الوسيطة، حتى نضج الفكر الإنساني واستطاع معرفة السبب الحقيقي للبرق بواسطة العلم الحسي التجريبي. لذا فإن تقدم العلم أكثر سيكون سبباً مباشراً لزوال الأديان والنظريات الفلسفية.
ومن هنا نرى الفيزيائي ستيفن هوكنك يؤكد في كتابه "التصميم العظيم" على زوال مرحلة الفلسفة وان الزمان زمان العلم.
فقد تبين أن القدماء لم يهملوا المنهج الحسي بسبب قلة نضوجهم العقلي، وإنما لطبيعة المسائل التي يحاولون البحث عن إجابتها، وهو في طبيعتها مسائل غير مادية لا تتناسب والمنهج الحسي التجريبي.